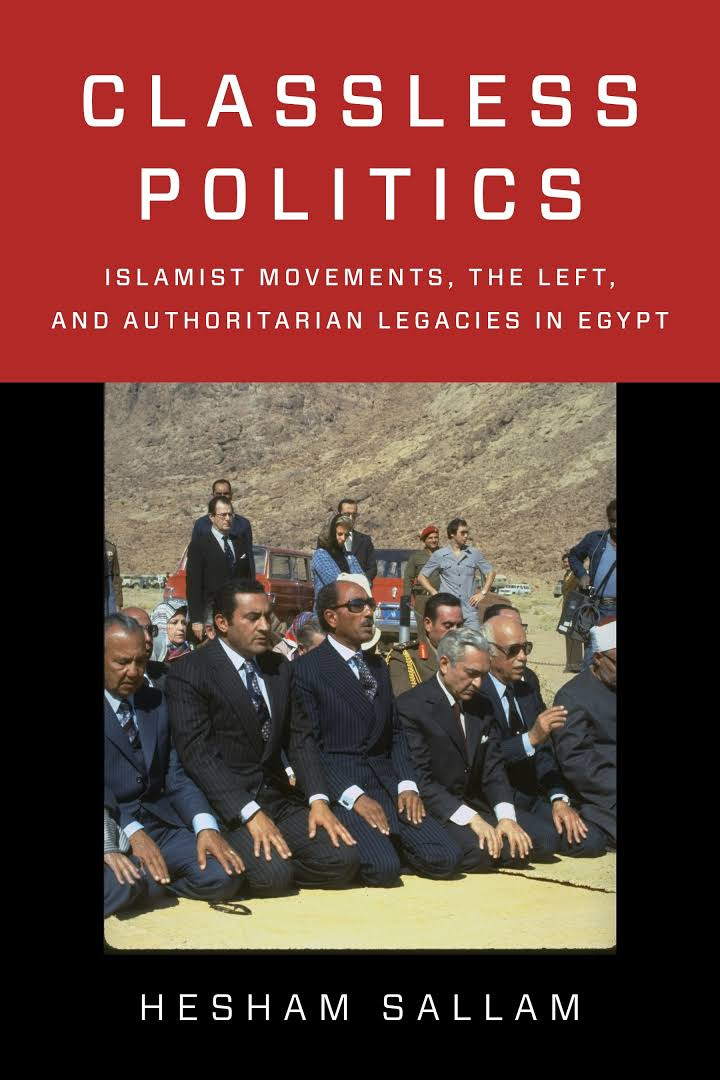لأعترف لكم، لقد تغيرت. قبل أكثر من 10 سنوات كنت لأدعم التحليلات القائلة إن نتيجة الانتخابات الأردنية دليل على شعبية التيارات الإسلامية، وعلى إمكانية التغيير في العالم العربي. اليوم، أنظر لهذه النتيجة من زاوية مختلفة. فالنتائج الحالية ليست دليلًا على شعبية التيارات الإسلامية، ولا هي علامة على حصول تغيير. هل يبدو موقفي متشائمًا؟
ربما، لكني أحب أن أنوه استباقًا أنه لا تزال لدي آمال في الشعوب العربية، وثقة في آليات المشاركة الشعبية، ولا يزال التغيير في العالم العربي ممكنًا. ما تغير هو النظرة لما حدث من زاوية مختلفة، وهي الزاوية التي تُظهر الأمور بشكل مغاير، لتؤدي إلى تحليلات واستنتاجات مختلفة.
الإسلاميون: وسؤال الشعبية
لدينا نفس الحدث، لكن بتحليلين مختلفين. الحدث: ارتفاع عدد مقاعد الإسلاميين في الانتخابات العامة. التحليل الأول: هذا دليل إضافي على شعبية الإسلاميين المرتفعة، وأنهم أمل الشعوب العربية. التحليل الثاني: هذا إشارة إلى سماح النظام السياسي بمساحة أوسع للإسلاميين من أجل تحقيق مصالح وفوائد للنظام. أي التحليلين تختار؟
هناك شخص يجيد هذه النقاشات جيدًا أجاب بأنه اختار الاثنين معًا. للأسف، لا أظن أن هذه إجابة صحيحة، رغم أنها قد تبدو وكأنها إجابة جيدة. وستعرف السبب بعد قليل.
لنبدأ بالتحليل الأول: يمكن قياس شعبية الإسلاميين صعودًا أو هبوطًا في حال لم تحدث تغيرات جوهرية في الظروف العامة المحيطة بالانتخابات وإجراءاتها. وقتها يصبح صعود/هبوط النتائج ذا دلالة على حجم التأييد الشعبي لهذه التيارات. يحدث هذا في الدول المستقرة سياسيًا والتي لديها نظام انتخابات منتظم وثابت. أزعم مثلًا أن أقرب مثال عربي لهذه الحالة هو المغرب، حيث استطاع حزب العدالة والتنمية المغربي عام 2016 الحفاظ على نتائجه البرلمانية الجيدة في انتخابات 2011، لكنه لم يستطع فعل ذلك في انتخابات عام 2021. هنا لدينا إمكانية حقيقية لتحليل هذا التراجع في الشعبية وفهم أسبابه.
التحليل الثاني يقول إن صعود أو هبوط الإسلاميين في العالم العربي لا علاقة له بالشعبية، بل بحجم المساحة التي يمنحها لهم النظام الحاكم. لذلك، فإن نتيجة انتخابات تظهر تقدم الإسلاميين تعني تلاقي مصالح النظام معهم، فسمح لهم بمدى حركة أوسع. أي أن هذه النتائج تشير بشكل أوضح إلى قرارات النظام ومصالحه وانحيازاته، أكثر من إشارته لحجم شعبية التيارات الإسلامية وتواجدها.
التفريق بين الحالتين يظهر أن توسيع مساحة الحريات لا يعني بالضرورة شعبية أعلى للإسلاميين، وإنما يعني سماح النظام السياسي بمساحة أكبر للحركة والعمل. والعكس صحيح أيضًا، فتراجع مقاعد الإسلاميين في الانتخابات لا يعني بالضرورة تراجع الشعبية، بقدر ما يعني ممارسة النظام الحاكم حملة قمع وتضييق على الحريات العامة.
هل يدفع هذا التفريق إلى نزع "القداسة" عن الإسلاميين؟ ربما. أنصح في هذه النقطة تحديدًا بالعودة إلى كتاب صدر منذ عامين تقريبًا للباحث هشام سلام عن دار نشر جامعة كولومبيا، يقارن فيه بين الإسلاميين واليسار في مصر: صعودًا وهبوطًا. والحجة الأساسية للكتاب تتكون من جزأين: جزء مشهور، وآخر جديد. المشهور أن صعود الإسلاميين في السبعينات ارتبط برغبة نظام السادات في معادلة قوة اليسار والناصريين عبر السماح بمساحات أوسع للتيارات المحافظة والدينية. استفادت التيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، من هذه المساحة. تراجعت سريعًا هذه المساحة في نهاية السبعينات. الجزء الثاني من الحجة الرئيسية يقول إن استمرار تأثير التيارات الإسلامية لعقود تالية كان نتيجة بنائها تنظيمات ذات طابع مؤسسي ومستقلة عن النظام، في حين مالت التيارات اليسارية للعمل معتمدة على النظام وفي أُطر لا تتميز بمؤسسات مستقلة وذاتية الحركة. المؤسسية والاستقلالية هما سر استمرار تأثير الإسلاميين وتراجع اليسار حتى ثورة يناير 2011.
ما علاقة هذا بالانتخابات الأردنية الحالية؟ يعني هذا أن وجود مؤسسات مستقلة للإسلاميين هو الذي يساعدهم على الحصول على نتائج جيدة في الانتخابات العامة، في حال قرر النظام توسيع المجال العام. أما مسألة الشعبية والدعم، فنحتاج إلى التفكير في قياسها بطرق أخرى بخلاف نتائج الانتخابات.
التغيير: وسؤال الكيفية
العلاقة بين الانتخابات والتغيير علاقة مُربِكة. فوز حزب سياسي في الانتخابات لا يعني بالضرورة حدوث تغيير، مادام الفوز غير مرتبط ببرنامج أو سياسات عمل الحزب على تطويرها وصياغتها قبل الانتخابات. الشكل الأمثل للتغيير عبر الانتخابات هو أن تكون الانتخابات "نهاية" ماراثون طويل، وليست "البداية". أن يكون الفوز في الانتخابات لحظة تلاقي عدد من الأنهار الصغيرة والمستقلة، لتشكل معًا نهرًا جديدًا واسعًا وعريضًا لا يشبه أي من الأنهار السابقة، لكنه في الوقت ذاته تشكل نتيجة اندماجهم معًا. حتى يتشكل هذا النهر الجديد، نحن بحاجة إلى مشكلة عامة تبحث عن حل، لتأتي الانتخابات العامة في ظل ظرف سياسي مواتٍ يسمح لشخص أو مجموعة بالدفع بحل أو سياسة محددة لهذه المشكلة، مستغلين الظرف السياسي و"نافذة الفرصة" المفتوحة.
لأكن صادقًا معكم، هذا طريق طويل وصعب. الأسهل دخول الانتخابات بخطابات شعبوية تُراكِم الدعم والتأييد عبر خطابات ثقافية لا تتبنى حلولًا أو سياسات محددة. فكر بها، أيهما أسهل: كسب أصوات الناخبين عبر القول "صوتوا لي فنحن من نفس الدين/العرق/القرية/القبيلة..."، أم صوتوا لي من أجل برنامج تأمين صحي شامل لكل المواطنين؟ حشد التأييد عبر الخطابات "الثقافية الشعبوية" أسهل من حشده عبر الاتفاق على برامج وسياسات. تتحول هذه السهولة إلى تحدٍّ كبير بعد الفوز في الانتخابات. لقد فزنا بدون برامج ولا سياسات محددة، فماذا عسانا نفعل الآن؟ الأمر مختلف في الحالة الثانية. يعطي النجاح في الانتخابات إشارة بدء العمل على ما تم الاتفاق عليه سابقًا. ليس بالضرورة كله، لكن جزء منه على الأقل. أي أن لحظة الوصول إلى السلطة هي نفس لحظة تشمير ساعد الجد والعمل، وليست لحظة التساؤل: ما العمل؟
لنأخذ مثالًا: ما برنامج عمل الإسلاميين في الأردن تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة؟ ما السياسات التي تسعى الجبهة لإقرارها والمختلفة عما يتم حاليًا والتي جمعت الدعم والتأييد الشعبي لها؟ الجواب يمكن أن يكتبه أنصارهم في التعليقات. أما بالنسبة لي، فالأمر بسيط: بعد 6-12 شهر سنعرف تحديدًا السياسات "الحقيقية" تجاه القضية. فإذا لم يتغير شيء بعد عام، فهذا يعني أن هذه الشهور مضت في محاولة الإجابة عن سؤال: ما العمل؟
التعليق الثاني يحتاج قليلًا من التفكير: لو كان لدى الحركة برنامج "حقيقي ومختلف" لنصرة القضية الفلسطينية يمكن أن يؤثر في وقائع الحرب الدائرة حاليًا، فإنها على الأغلب ما كانت لتحصل على هذا العدد من المقاعد. فكر بهذا.
هذا المثال يعيدنا إلى أهمية بناء دعم شعبي لمطالب محددة، تكون الانتخابات هي اللحظة الكاشفة لحجم الدعم الشعبي لهذه المطالب، لا اللحظة المنشِأة لها. تجاوز الدعم المعنوي/الرمزي لفلسطين في ظل سياق رسمي إقليمي ودولي ضد القضية الفلسطينية لن يكون بالأمر الهين. يستلزم بناء سياسات وبرامج عمل، قرينة الخطابات والشعارات الصادقة.
قبل السلام
أهل الأردن أدرى بشعابها! ليكن ذلك صحيحًا. لا يغير ذلك من الأمر شيئًا، فلكل شخص حاليًا القدرة على الكتابة والتعليق والتصوير والنشر. هذا هو الواقع الجديد الذي نتعامل معه. ولا يمكن - بل وليس من المستحب - الحجز على تعليقات الناس ومشاركتهم في النقاشات العامة، حتى لو بدت لنا غير صحيحة!
النتائج التي وصلت إليها خاطئة! ليكن ذلك صحيحًا. لا يغير ذلك من الأمر شيئًا، فليس المهم توقعنا لما سيحدث بعد 6 شهور أو سنة، بل كيف نفكر وبأي طريقة. قد تحدث عوامل خارجية تساعد الجبهة على تحقيق تقدم ما، أو تعيقها في تحقيق ما تريد. لكني أزعم أنه حتى لو حدث ذلك، يظل هذا التحليل يحمل قدرًا من المصداقية. والله أعلم.
يمكنكم قراءة المقالات السابقة من خلال هذا الرابط