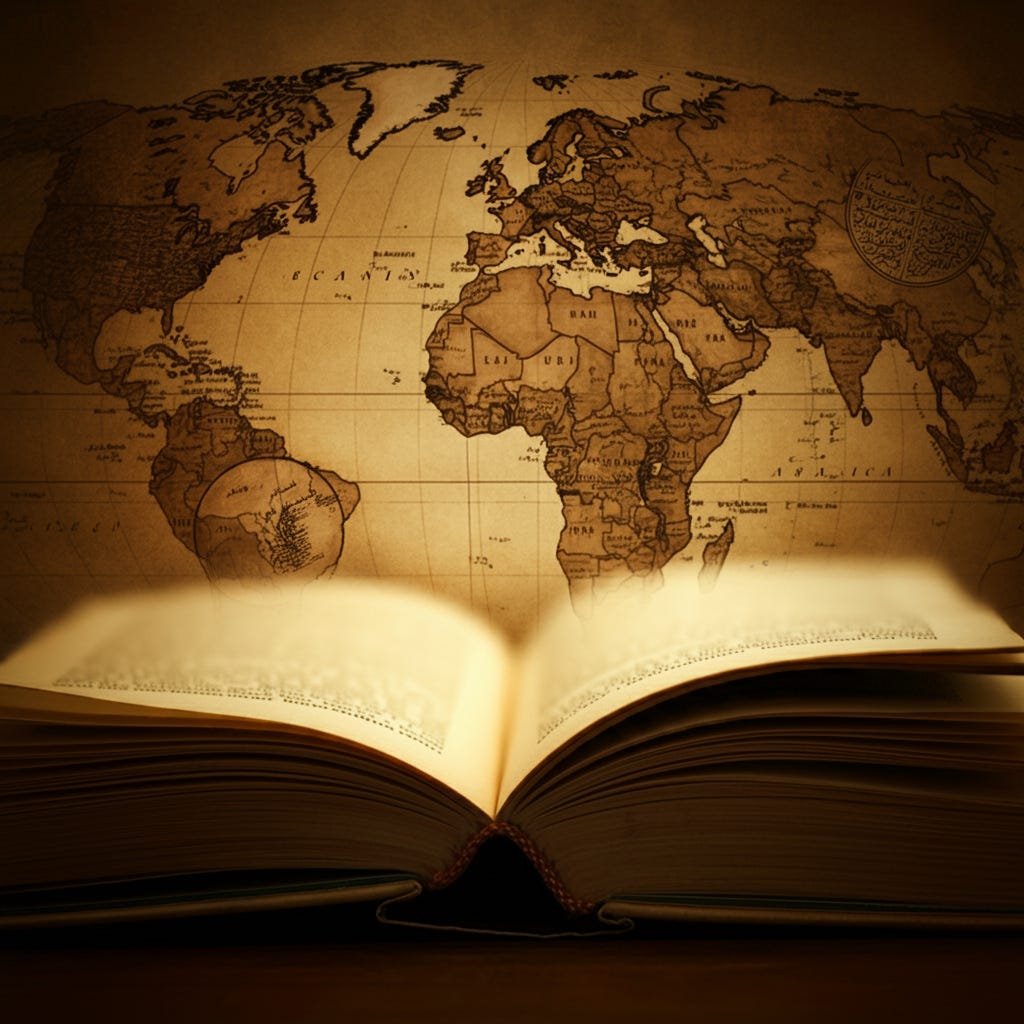بين الكولونيالية والمعرفة المحلية:لماذا اختار النشر الاكاديمي باللغة العربية؟
قال لي أصدقائي إن هذا القرار غير صائب، لكن مع مرور الوقت، يتزايد عدد الحجج المؤيدة لهذا القرار. في البداية، لم أكن مدركًا لكل هذه الحجج أصلاً؛ كان لدي دافع أو اثنان لاتخاذ هذا القرار. ولكن مع التفكير بشكل أعمق، وجدت الدوافع المؤيدة لموقفي كثيرة ومتنوعة، وبعضها لم يخطر على بالي رغم أهميته. القرار: كلما كان ذلك ممكنًا، سأقوم بالكتابة والبحث والنشر باللغة العربية، وليس باللغة الإنجليزية!
لنتذكر،هذا قرار ليس سهلاً لأشخاص يرغبون في العمل والتطور داخل المجال الأكاديمي؛ فالكتابة والنشر باللغة العربية تعني "الموت الإكلينيكي". بالطبع، هناك نشر أكاديمي باللغة العربية، لكنه حتى لو كان جيداً فلا يحظى بالاعتراف الكافي خارج العالم العربي. لذلك، قرار النشر الاكاديمي باللغة العربية يعني الحكم على المسار المهني بالإعدام. الترقيات، فرص العمل الجيدة، المنح البحثية كلها مرتبطة بالنشر باللغة الإنجليزية للحصول على الاعتراف من المؤسسات الأكاديمية المرموقة والمنظمات الدولية، وهو الاعتراف الذي يفتح الأبواب على مصراعيها. وبدون هذا الاعتراف، تكون الفرص محدودة وذات مستوى متواضع.
ما الذي دفعني لاتخاذ هذا القرار؟ ولماذا، كما يقول أصدقائي المخلصون، حكمت على نفسي بالإعدام المهني؟ الإجابة تحتاج إلى مزيد من التفصيل، وبعض الحكي.
درست الطب باللغة الإنجليزية كما هو مذكور في الأوراق الرسمية، لكن التدريس في الواقع كان باللغة العربية مطعمًا بالمصطلحات الإنجليزية. لا يدخل الأساتذه الجامعيون قاعة الدرس للحديث طوال الوقت بالإنجليزية، بل بالعربية مع إدراج المصطلحات بالإنجليزية. بعد انتهاء البكالوريوس، أدركت أنه مع دراستي الطب لسبع سنوات متواصلة باللغة الإنجليزية فإن مستوى لغتي الإنجليزية ضعيف. كنت قادرًا على الحديث عن الأمراض والعلاج بالإنجليزية، ولكن في الحوارات العامة كانت تخونني لغتي الإنجليزية.
لذلك، في سنة الامتياز، ذهبت لأفضل المراكز الدولية مقتطعًا من ميزانيتي الصغيرة للاستثمار في تعلم اللغة. وعلى الرغم من معاناتي المالية لتأمين هذه الدورات، فإني أدرك الآن أن أفضل عائد استثماري حصلت عليه في حياتي كان جراء تعلم الإنجليزية. وكنت أخبر أصدقائي في حال السؤال أيهما أفضل: الحصول ماجستير باللغة العربية أم تعلم اللغة الإنجليزية؟ بأن تعلم الإنجليزية يعادل الحصول على شهادة ماجستير، بل أفضل!
أما دراسة السياسات العامة، فكان من المفترض أن تكون باللغة العربية. لكن، على غرار ما حدث في دراسة الطب، كانت جميع القراءات والمراجع باللغة الإنجليزية، بينما ظلت النقاشات داخل القاعات باللغة العربية. من يعرف الإنجليزية يستفيد، أما من لا يعرفها فيعاني في المتابعة والتحصيل. وكان المطلوب أن تكون الأوراق البحثية والتكليفات باللغة العربية، لكن نصيحة المخلصين كانت بعدم إضاعة الوقت في الكتابة بالعربية والتوجه مباشرة إلى الإنجليزية. اقتنعت بالنصيحة، وبدأت مبكرًا بالنشر باللغة الإنجليزية والمشاركة في المؤتمرات الدولية. لكن، عندما سلكت هذا الطريق، أدركت أني سأتوه فيه مثلما حدث لعطا المراكيبي في حديث الصباح والمساء!
مصانع "إنتاج" المعرفة تتمركز في عدد محدود جدًا من الجامعات المرموقة عالميًا، تعمل في منظومة شبة احتكاريه. خريجو هذه الجامعات غالبًا مايستمرون داخل هذه المنظومة الضيقة. توجد طبقة أخرى من الجامعات تساهم بالأساس في "اختبار" وتطوير المعرفة، ورغم أن عددها أكبر من المجموعة الأولي، فإنها تظل ضمن النخبة. تأتي بعدها جامعات من الدرجة الثالثة تقتصر على "تقليد" المعرفة، عددها بالآلاف، ويتفاوت جودة إنتاجها.
تتولد لديك صورة النظام الأكاديمي هذه من خلال حديث بسيط مع خريجي جامعات المجموعة الأولى، لكن تطرح هذه الصورة أسئلة حول موقعنا ضمن هذه المنظومة. وكيف يحدد المعرفة التي نستهلكها وننتجها؟ هل الأفضل نسخ وتطبيق النماذج الغربية مباشرة، أم التفكير في طرق وأسئلة تتناسب مع بيئتنا المحلية؟
من هنا تأتي أهمية النظر في كيفية إنتاج وتدريس المعرفة في الجامعات غير الغربية، وخاصة في دول الجنوب العالمي، والاسئلة المصاحبة لهذا النظر:
لمن ننتج المعرفة؟
وما القيم والمصالح التي تخدمها؟
وكيف نختار المناهج التي ندرسها؟
تُصبح هذه الأسئلة ملحة عندما ندرك أن اتباع النموذج الغربي دون تعديلات يعيق تطوير معرفة تخدم مجتمعاتنا المحلية. فكروا فيمن قام بالتدريس لكم في الجامعة وخلفياتهم وأصولهم وانحيازتهم وطبقاتهم الاجتماعية وطرائق تعليمهم. فكروا في المحتوى التعليمي الذي قُدم لكم وإلى أي مدى كان مرتبط بالمكان الذي نعيش فيه. فكروا بالطريقة التى تمت بها عملية التدريس، وطرائقها والأدوات المستخدمة. إجابة هذه الاسئلة يمكن أن تشاركوها مع أصدقائكم أو معانا، لنتفكر فيما جري ويجري.
على سبيل المثال، قد يكون أمرًا منطقيًا أن تنتج جامعات أمريكية معرفة تلبي احتياجات الولايات المتحدة، الغير المنطقي أن تقوم الجامعات خارج الولايات المتحدة الأمريكية بعمل الشئ ذاته! ولنعد إلى المجال الطبي لنعطي مثالًا على ذلك.
الاحتلال الإنجليزي لمصر كان عاملاً رئيسيًا في إعادة تشكيل المجال الطبي المعرفي لخدمة المصالح الكولونيالية بدلاً من خدمة المجتمع المصري.عرفت ذلك بوضوح أثناء شرحي لكتاب الطب والأطباء في مصر عند مناقشة موضوعين: الأول يتعلق بلغة تدريس الطب في مصر، والثاني بأولويات الممارسة الطبية.
كان محمد باشا البقلي رئيس المدرسة الطبية المصرية قبل الاحتلال الإنجليزي. درس في فرنسا وعاد للعمل في مصر، ولكنه قرر أن تكون دراسة الطب باللغة العربية، وشجع ترجمة الكتب الطبية الفرنسية والإنجليزية إلى العربية، وكتب بنفسه في المجال الطبي باللغة العربية، وأصدر نشرة دورية للتثقيف الطبي بنفس اللغة. التحول إلى التدريس باللغة الإنجليزية حدث بعد الاحتلال بخمس سنوات، وكانت الحجة جاهزة: تعلم الطب بالإنجليزية يمكن الأطباء المصريين من الانخراط في النظام الطبي الإنجليزي فيرفع من مستواهم، كما أنه يفتح لهم فرصة العمل ضمن هذا النظام في حال سافروا له. حجة قوية لايمكن مقاومة إغرائها حيث توفر فرصًا براقة للأطباء المصريين. لكن هذا الإغراء يعيد طرح الأسئلة الجوهرية: هل يخدم الأطباء المصريون مصر أم بريطانيا؟ وهل يجب أن تركز الممارسة الطبية في مصر على احتياجات المصريين أم على مصالح القوى الاستعمارية؟
لنأخذ مثال أخر. رأي اللورد كرومر أن الأولوية في الممارسة الطبية المصرية هي لـ"مكافحة الأوبئة". السبب في تقديره أن هذه الأوبئة تشكل خطرًا على بريطانيا ومستعمراتها نظرًا لموقع مصر الجغرافي كمحطة وسيطة في التجارة الدولية. في المقابل، رأى الأطباء المصريون في معظمهم أن التهديد الأكبر لصحة المصريين هو "الأمراض المتوطنة"، مثل البلهارسيا، التي تسببت في العدد الأكبر من الوفيات. الأولوية إذاً ينبغي أن تكون لدراسة الطفيليات المرتبطة بهذه الأمراض. يتجلى هنا بوضوح وجود رؤيتين مختلفتين للتعامل مع الممارسة الطبية: الأولى تربطها بالاحتياجات الاستعمارية، والثانية بالاحتياجات المحلية للمصريين. فماذا نختار؟
لنعد الآن لموضوعي الشخصي. عندما يكون النشر باللغة الإنجليزية، يكون الجمهور المستهدف غالبًا في الدول الغربية أو الناطقين بالإنجليزية في العالم العربي.
في المقابل، لو كانت الكتابة الأكاديمية في الجامعات الكبرى باللغة العربية فإن هذا لوحدة كافي، في رأيي، لتحسين جودة النقاشات الاكاديمية والعامة. هل جمهوري المستهدف موجود في الدول الغربية أم في المجتمعات العربية؟
هنا، يجب التفريق بين أمرين: ضرورة إتقان اللغات الأجنبية وفهم المناهج الغربية، وهو أمر أساسي لإنتاج المعرفة، وبين ضرورة أن يكون النشر باللغة العربية ليصل إلى جمهور أوسع ويدفع أصحاب المصلحة المحليين إلى الاشتباك بشكل أفضل. فالمعرفة المنتجة في الغرب ليست "نجسة" ولاهي "عديمة الفائدة"، بل هي مفيدة وملائمة لسياق معين، ولكن لا يعني ذلك أنها تصلح لكل السياقات. هذا التنوع في المعرفة لا يجب أن يمثل مشكلة لأحد. يمكن للعالم العربي إنتاج معرفة قيمة تفيد مجتمعاته، دون الادعاء بأنها المعرفة الوحيدة الصحيحة، كما يمكن لباقي المجتمعات أن تفعل ذلك أيضًا دون أي إدعاء زائف بالأفضلية.
ولا أظن أن هناك تناقض في التحريض على تعلم اللغة الإنجليزية، وفي التحريض في الوقت ذاته على النشر باللغة العربية. فلا سبيل للتراجع عن تعلم اللغات الاجنبية إذا اردنا فعلًا المساهمة بشكل فعال في إنتاج المعرفة. حجم استفادتي من الإطلاع على المراجع المكتوبة باللغة الانجليزية سواء اثناء دراسة الطب أو اثناء السياسات العامة هي استفادة مهولة، والتخلي عنها قرار غير متصور. الذي تغير في تفكيري هو أهمية التنوع في المدخلات، وأن تنصب المخرجات على خدمة السياق المحلي. فالاستفادة تكون أعظم بمزج مصادر التعلم باللغة الإنجليزية مع العربية في تضفير متصل وجميل، أما المخرجات فستكون أقيم وأنفع إذا كانت وجهتها هي خدمة المجتمعات المحلية واحتياجاتها.
فك الارتباط بين الحالة الكولونيالية والحداثة عند استهلاك وإنتاج المعرفة هو خطوة أولى نحو معرفة قيمة ومفيدة لتطلعات شعوبنا. يؤثر موقعك في السلطة أو قربك منها على نوع السياسات العامة التي تنتجها أو تستهلكها. يركز القريب من السلطة على الموارد المالية والإمكانيات السياسية، بينما يفكر أصحاب المصلحة في حل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم الخاصة. بالمثل،فإن موقعك في المؤسسات الأكاديمية قد يدفعك في اتجاه مختلف عن ذلك الذي كنت ترغب فيه لو كنت تعمل في مؤسسات محترمة محلية أو وطنية.
أخشى أن يظن بعض القراء أن ما أدعو إليه هو مجرد مطالب "أكاديمية" تخص الباحثين. أعادت حروب اسرائيل في المنطقة تذكيرنا بالكولونيالية، ليس بصيغتها الرمزية، بل بشكلها الاستعماري المباشر والصريح. تقتل اسرائيل وتقوم بإبادة جماعية ثم تحدد بعد ذلك من الذي يحصل على الطعام والشراب والخدمات الصحية ومن يُحرم منها. لقد ظهر الاستعمار بأكثر صورة وضوحًا وهمجية، ومقاومته تبدأ بالتخلص منه في جميع المجالات: من السياسة إلى المعرفة. لقد حصلت الدول الإفريقية والآسيوية على الاستقلال السياسي منذ أكثر من نصف قرن، لكن الكولونيالية كحالة ظلت مستمرة. وإذا أردنا ألا نكرر نفس هذا الخطأ مستقبلًا، فينبغي العمل على القضاء على الكولونيالية كحالة بالتوازي مع التخلص منها كواقع سياسي وعسكري.
يمكنكم قراءة المقالات السابقة من خلال هذا الرابط